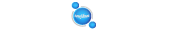مشاكل التعليم بالمغرب : التبعية والارتجال والتجريب
من اعداد الكاتب سعيد يقطن
من اعداد الكاتب سعيد يقطن
مشاكل التعليم بالمغرب لا حصر لها إلى حد أن صار التعليم في حد ذاته مشكلة، بل أم المشاكل. والكل مجمع على أن هذه المشاكل تفاقمت حتى بات من المستحيل على أي كان الهروب إلى الأمام أو ادعاء صورة مزيفة عن واقعها.
ولعل الخطاب الملكي لمناسبة عيد العرش وضع اليد بجرأة نادرة على الحقيقة بكشفه أن الوضعية لم يعد بالإمكان تجاهلها أو السكوت على مآلها. لقد صار التعليم بالمغرب مثل رأس الأقرع «فين ما ضربتيه يسيل دمو»؟ وبما أن هذا الواقع وليد تاريخ، كان الرأس رأس يتيم، وكل من يجيء من المسؤولين يتعلم فيه الحجامة ويعلمها. ها قد كبر الرأس، وكبرت معه ندوبه وجروحه وكلومه. ولم يبق وقت للكلام، فما العمل؟ وبم نبدأ؟ وقد استطال حبل الحديث وكثرت التصريحات والتلميحات.
قد لا نختلف في التشخيص، حين نركز على التفاصيل ونقف على الظواهر أو نترصد المظاهر، لكنها جميعا ليست سوى تجليات ونتائج. وبدون السعي إلى البحث عن الأسباب البعيدة، والكشف عن الجذور الحقيقية، أي الرؤية التي تحكمت في سياساتنا التعليمية، لا يمكننا فهم لماذا آلت الأمور إلى هذا المآل الذي لم يعد يرضي أحدا أو يدعي واحد أن من الممكن الاستمرار على ما هو عليه.
أركز على أربعة أعطاب أصلية واكبت واقعنا التعليمي، منذ الاستقلال، وتولدت منها، مع الصيرورة، أعطاب فرعية عديدة. هذه الأعطاب المترابطة هي: التبعية، والارتجال، والتجريب، والتنجيح.
ورث مغرب الاستقلال ثلاثة أنظمة تعليمية: الجامع، المدرسة الحرة، «السكويلة»: تقليدي، شبه تقليدي، عصري. تعايشت هذه المدارس الثلاث، وصار لكل منها تاريخها. سأركز على السكويلة، التعليم العصري الذي تبنته الحكومات المتعاقبة، وعملت على تطوير بنياته ومنظوماته باعتباره النظام الوطني الأساس. تظهر التبعية في النظام التعليمي الحكومي، على مستوى البرامج والكتب المدرسية، صبيحة الاستقلال في احتذاء نموذجين متناقضين: المشرقي والفرنسي. وكان الهدف من النظام تكوين الأطر بالدرجة الأولى، ومحاربة الأمية في مستوى ثان. ورغم «مغربة» الكتاب المدرسي في الستينات، ظلت المقاربة التربوية تقليدية في كل المواد: اعتماد التلقين والحفظ، ثم كانت محاولات لتجديد البرامج والطرق البيداغوجية في أواخر السبعينات، وتم بعد ذلك، إحداث الأكاديميات والجامعات الجديدة، والميثاق، فالبرنامج الاستعجالي، لكن التبعية ظلت هي السائدة، حيث يتم اللجوء إلى التجارب الغربية فرنسية أو كندية، ويكون استنساخها و«تعريب» أدبياتها وتقديمها على أساس أنها المقاربة الجديدة للخروج من الوضع القائم.
وعندما تغير فرنسا، مثلا، نظام تعليمها العالي باعتماد «الإمدال» (إ.م.د) ومدارس الدكتوراه، نبادر إلى السير على منوالها دون أخذ الوقت الكافي للتجديد أو توفير الشروط الملائمة له. ولم يكن ينجم عن التبعية غير الارتجال.
طبع الارتجال كل هذه الصيرورة، وكانت تحصل التغييرات في أوقات الأزمات التي نصل فيها إلى الطريق المسدود، وتظهر النتائج عكس المتوقع، فتكون الاضطرابات والإضرابات إعلانات عن فشل السياسات التعليمية: 1965 ـ 1979 ـ 1990 ـ 1999 ـ 2009، أي أننا منذ بدء العمل بـ"إلزامية التعليم" إلى "مدرسة النجاح"، ونحن ندخل في مسار، لنخرج منه إلى آخر، غير موفرين الشروط الضرورية لأي انتقال. وكلما جاءت حكومة جديدة تحاول التخلي عن المشروع السائد، فلم نراكم من هذه الصيرورة غير النتائج الكارثية.
ورغم مرور أكثر من نصف قرن على الاستقلال ما تزال الأمية الأبجدية ضاربة أطنابها، ولا حديث عن الأميات الأخرى. قد تعلق هذه النتائج أحيانا على التعريب، أو تتوجه باللائمة على الأطر التربوية، أو على البرامج، وكلها ذرائع لا أساس لها. فالمشكل الحقيقي يكمن في الاختيارات التي لم تكن مبنية على أسس سليمة. وحين يكون التغيير مبنيا على "قرارات" عاجلة، يسود الارتجال ويهيمن التجريب.
يبرز التجريب في كون انتقالنا من تجربة إلى أخرى لا يكون بناء على إعداد كاف سواء على مستوى التأطير أو التكوين أو التخطيط. فيظل الغموض سيد الموقف: لقد اعتمد مثلا تحليل المؤلفات بالمنظورات الستة (وهي طريقة هجينة وملفقة)، ولم تكن مفهومة لدى الأطر التربوية، وكان كل "يجتهد" بما يراه. ويمكن قول الشيء نفسه عن بيداغوجيا الإدماج التي "مورست" ولا أحد يعرف معناها. جئت بهذين المثالين فقط لإبراز أننا عندما ندخل في مخطط لـ"التجريب" لا نهيئ له الشروط الحقيقية للنجاح، فتكون النتائج بالضرورة كارثية، فلا الأطر التربوية ولا أساليب المراقبة تتطور أو تتجدد أو تنخرط في "التجربة" الجديدة، بروح جديدة ووعي جديد.
وبذلك تغدو أي تجربة جديدة بمثابة "قالب" جديد (شكل)، ولكننا نصب فيه محتوياتنا القديمة. فلا يكون التلاؤم بين الشكل والمحتوى. يسري هذا على كل أسلاك التعليم: لقد انتقلنا، مثلا، في العالي من النظام القديم إلى الإمدال: فتغيرت المواد والمقررات، ولكن المحتويات ظلت هي نفسها: لقد تم "تكييفها" حسب الحاجات الجديدة. ومعنى ذلك أن التغيير يظل سطحيا فقط: فلا فرق في الجوهر بين المحاضرة في المدرج، و"الدرس" في القاعة، فأعداد الطلبة، رغم التفويج، ظلت هي نفسها... إننا نجرب طريقا جديدة بوسائل، وفي شروط، قديمة. ورغم كل ما يقال في وصف واقعنا التعليمي من لدن الفاعلين والمسؤولين، وما كتب عنه من مؤلفات، نجد الـ"نجاح" والانتقال من مستوى إلى آخر، وبنسب مئوية عالية جدا سيد الموقف.
ويكفي الوقوف على معدلات الباكلوريا هذه السنة، والتي كانت تصل إلى 19 على20؟ للتساؤل عن الواقع الحقيقي لتعليمنا. إنه العطب الرابع الذي أسميناه: التنجيح؟
التنجيح ليس النجاح، فكلما جربنا مخططا جديدا، ونحن لا نوفر له أدنى مستلزماته، نعمل على "تنجيحه" بأي شكل وصورة. فالأكاديميات عندما أسست صارت وكأنما أقيم لها هدف واحد هو التنافس على التنجيح. فصار التباري على أعلى المعدلات، وبرزت ظاهرة "نفخ" النقط. وتقدم حصيلة المواسم الدراسية "نسب النجاح" على أنها نجاح لهذا المخطط أو ذاك. صار "التنجيح" ذا بعد سياسي بلا بعد تربوي. ولذلك اقترن بـ"المقاربة الأمنية" التي باتت المحدد الأساس للسياسة التعليمية. إن ما يهم هو "تنجيح" التجربة بغض النظر عن الواقع المزري.
منذ أواخر السبعينات، صارت المقاربة الأمنية (الداخلية) هي المتحكمة في المسار التعليمي والمسيرة له بشكل لافت. وصار الشعار الأساس: الأمن لا التربية. وحين ظهر أن المعارضة تشتد داخل الجسم التعليمي، اعتبرت "الفلسفة"؟ هي المسؤولة عن ذلك. فتمت محاربتها بـ "الفكر الإسلامي" في الثانوي، و"الدراسات الإسلامية" في الكلية. ولما اشتدَّ عود الإسلام السياسي في بداية الألفية الجديدة، تم تقليص المواد الإسلامية لفائدة "العلوم الإنسانية" التي سارت مسلكا في الثانوي، وفتحت شعبتا علم الاجتماع والنفس في كليات الآداب؟ إننا لا ندرس المواد الفلسفية أو الدينية لحاجتنا إليها ليكون تكويننا صلبا، ولكن لضرورة إيديولوجية مؤقتة؟
إن ما تحكم في تعليمنا هو المؤقت والمستعجل، لذلك لم تكن عندنا رؤية "وطنية" بعيدة المدى وسياسة ملائمة لواقعنا ومتطلباته الحقيقية. ولذلك لم ننجح في محاربة الأميات المختلفة، ولم تحقق مدرستنا النجاح. لا مراء في أن التجديد والتغيير التربويين ضرورة واقعية. لكن شتان بين التجديد والتجريب، وبين النجاح والتنجيح. وبين التغيير الحقيقي والسطحي، وبين الارتجال والرؤية الوطنية المبنية على الاستفادة من تجارب الأمم لا استنساخ التجارب الرديئة والملفقة. ولذلك كانت كل "البدائل" المقدمة لإصلاح التعليم تصب في المسار نفسه: إعادة إنتاج الأميات، وتفريخ العاطلين، ومراوحة المكان على المستوى التربوي والعلمي والمعرفي، وأخيرا، التأخر عن عصر مجتمع المعرفة.
حين "تُخرِّج" مدرستنا موظفين، ولا "تنتج" العلماء، فهذا دليل على نقصانها وعطبها
بقلم : سعيد يقطين، كاتب وناقدج الصباح 29 غشت 2012